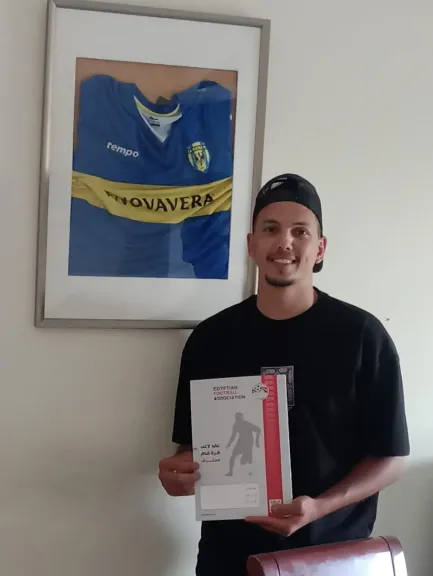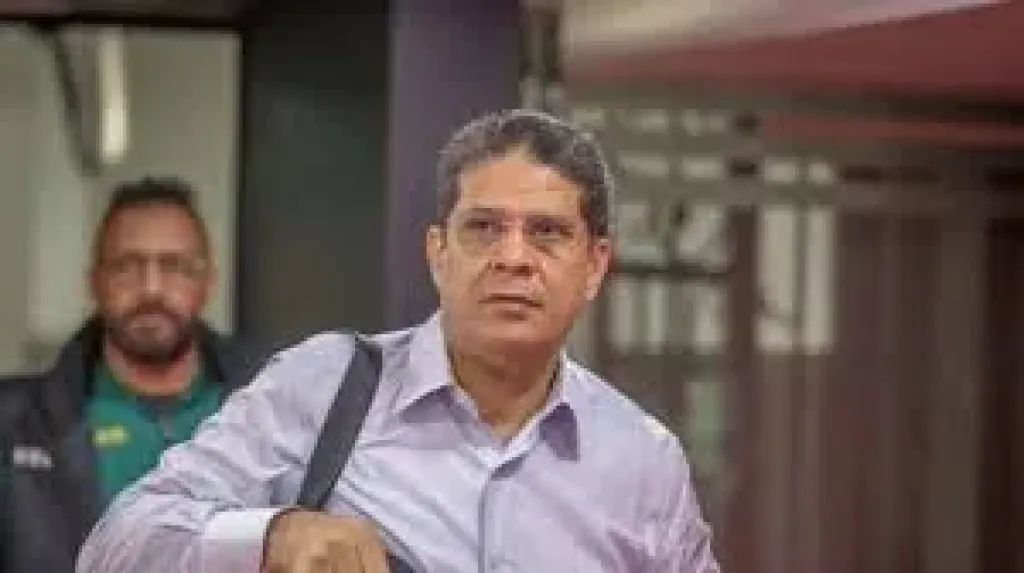المنايفة في زمن المماليك

الأتراك معظمهم كانوا «عواطلية» أو حكامًا.. والوثائق تظهر انحياز القضاة لهم
أصل المنايفة فلاحون وعربان.. واليهود اندمجوا معهم وتاجروا في المحاصيل
العودة للأصل تحتاج الكثير من البحث والتنقيب والتفتيش.
وهنا سنسعى للعودة إلى أصل المنايفة، وكيف تكون المجتمع المنوفى واستقر حتى أصبحت أقاليمه وخريطتها على ما هى عليه الآن.
ويقتضى الأمر الرجوع لأكثر من مائتى عام على الأقل، لمعرفة الجذور التى شكلت المجتمع المنوفى، وهى بالمناسبة جذور تتقارب فى بعض جوانبها من كافة أقاليم الدلتا.
فى البدء كانت الزراعة فى المنوفية.. الأرض خصبة وعفية ولا تحتاج لكثير من الأسمدة والمخصبات حتى تمنح خيرها للفلاحين.
توالت الأنشطة الصناعية والتجارية على هامش المتن الأساسى للمحافظة، وهو الزراعة.. وبين التجارة والصناعة والزراعة وحكام الأقاليم أطياف لا حصر لها من المرابين والتجار والفلاحين والعرب واليهود واليونانيين الذين جاءوا جميعهم إلى المنوفية، بحكم الرغبة فى التجارة أو الاستقرار.. فأصبحت المنوفية بين سنة وأخرى نموذجًا لأجواء كوزموبوليتانية على مستوى إقليمى.
العائلات الكبيرة والصغيرة
من المعروف أن مصر ظلت مجتمعًا زراعيًا بالأساس حتى شهدت تحولات كبرى على يد محمد على باشا، الذى أدخل أنماط إنتاج أخرى عمودها الرئيسى الصناعة والزراعة المنظمة.
وفى المنوفية، عاش نحو 80 % من سكانها فى المناطق الريفية، وكان نشاطهم الأساسى حتى نهايات القرن الثامن عشر الزراعة.
ويفيدنا تعداد السكان، أو ما كان يطلق عليه تعداد النفوس، الصادر عام 1848 بحقائق كثيرة حول عائلات المنوفية وعلاقات الصهر والنسب بينها، وحجم العائلات آنذاك ونسب الغرباء عن المنوفية.
وكانت العائلات الكبيرة فى الإقليم هى الأساس وتمثل أكبر نسبة للسكان، وتكتلت تلك العائلات بينها بأواصر القرابة والصهر، وتوزعت فى معظم أرياف المنوفية، مثل عائلات رسلان وعبدالغفار وشنشين، وفى منوف عائلات الشقنقيرى والبيه ونور وأبوحصوة والجندى والفيشاوى، وفى ناحية شبين الكوم حتحوت وسراج وسعفان والقط والنجار والعالم والسنطاوى. وفي ناحية الباجور الحروبة وهليل وبهلول والشاذلى، والأخيرة اكتسبت سمعة كبيرة بسبب العلاقات التى كانت تربط كمال الشاذلى تحديدًا بالدولة وعضوية مجلس النواب.
كما يتبين من تعداد النفوس أن الأغراب عاشوا بين المواطنين الأصليين للمنوفية جنبًا إلى جنب، وكان التنقل والارتحال سمة أساسية فى تاريخ عائلات الإقليم، فعدد الغرباء مثلًا فى شبين الكوم بلغ 33% من الأصليين، فى أربعينيات القرن الـ18، وفى منوف بلغ نحو 12% من السكان. وأطلقت الحكومة على الغرباء «المتسحبين».
وبالإضافة للعائلات الكبيرة، كانت تعيش عائلات صغيرة فى تعدادها، واتسمت بأنها تسعى لزيادة أعدادها، إلا أن كثيرين منهم كانوا يتسربون ويهجرون قراهم بحثًا عن الرزق فى الحضر أو قرى أخرى أكثر وفرة فى الرزق، أو هربًا من حكم بالسجن والضرائب والعمل بالسخرة فى أحد المشروعات التى تنفذها الحكومة.
ويقول الدكتور حلمى أحمد شلبى، فى كتابه «المجتمع الريفى فى عصر محمد على»، إن قرى وبنادر الإقليم كانت بمثابة إقطاعات فى أيدى مشايخ كبار العائلات، بفعل قوانين محمد على الزراعية الجديدة، إذ تمثل كل ناحية أو قرية حصة أو عدة حصص لأحد المشايخ أو عدد من الشيوخ، بحيث أصبح كل شيخ مسؤولًا عن حصته فى كافة الأمور.
أما العائلات الصغيرة، فسادتها حالة من التفكك والانقسام، وانحصر ولاؤهم فيما بينهم للقيم المتولدة عن الإنتاج الزراعى الذى لا يكاد يكفى حد الكفاف، لذا كان التفتت العائلى من السمات الأساسية لها، وكانت تخضع بشكل شبه كامل لسلطة شيوخ القرى.
وقضى هؤلاء الشيوخ على أى محاولة للعائلات الصغيرة للظهور، وفى بعض الأحيان كان يلفق شيخ القرية تهمًا لأسرة فلاح ظهرت عليه معالم الثراء للتقليل من شأنه.
البدو المتمردون
البدو، أو كما أطلق عليهم «العربان» فى المنوفية، كانت أعدادهم تتزايد، وكانوا يخضعون لنوعين من الولاية، ولاية شيخ البلد الطبيعية، وولاية شيخ القبيلة.. ومعظم هؤلاء تواجد بالأساس فى كفر بالمشط وأسريجه وأشمون وجزى، وهم بالتحديد من قبائل الجوابيص والقذاذفة والحرابى، نسبة إلى قبيلة حرب، وكانت تتميز على أفراد العائلات الصغيرة بأنها منعزلة ولا تختلط بهذه العائلات إلا للضرورة القصوى.
وتبين الوثائق آنذاك أن العربان كانت تميزهم روح التمرد والعصيان على السلطة الطبيعية فى القرى، باستثناء سلطة شيخ القبيلة عندهم.. يقول أحد العربان ـ مثلا ـ أمام قاضى إقليم المنوفية عام 1848 «إننى أعترض على المجلس الشرعى للإقليم، وإن شرع الله عند غيركم»، قاصدًا شيخ قبيلته.
الأتراك.. الأقلية المسيطرة
من قراءة «تعداد النفوس» أيضًا يتبين حجم الأتراك الذين عاشوا فى المنوفية، وكانت نسبتهم ضئيلة للغاية، إلا أنهم كانوا يتمتعون بالحصانة المبنية على عرقهم ونسبهم، وعلى استغلال ثروة الإقليم الاقتصادية.
كان الأتراك والعثمانيون هم قمة الهرم الاجتماعى للسلطة فى قرى مصر، وبالتالى فى المنوفية، وفى قمة هرم الثروة أيضًا، وكانت مهمتهم سواء بكوات أم أغوات هى تنفيذ سياسة الحكومة المركزية فى الإقليم وتأكيد سلطة محمد على وتوطيدها ودعمها، استنادًا إلى نظام الاحتكار.
تشير الأرقام مثلًا إلى أن تعداد منوف عام 1846 بلغ نحو 10 آلاف نسمة، ولم يتعد تعداد الأتراك 295، وأشمون أكثر من 4 آلاف نسمة، منهم 67 فقط تركيًا، والباجور 4 آلاف نسمة، منهم 54 تركيًا.. وهكذا يتبين أن نسبتهم لم تكن تتعدى فى أفضل الأحوال 3% من تعداد السكان.
لكن هؤلاء الأتراك تميزوا جدًا عن غيرهم.. فما الذى ميزهم؟.
مبدئيًا، كانت الوثائق الحكومية تنعتهم بأنهم «خارج الحكومة» أو «الأقلية المميزة»، بحكم استحواذهم على المناصب الإدارية والسلطة فى الإقليم، والملكيات الزراعية الشاسعة قياسًا بكبار وصغار العائلات.
وبما أن هؤلاء يمثلون السلطة فى أفدح صورها، كان القضاة يسعون لإرضائهم على حساب الفلاحين.
وتكشف أوراق المحاكم السائدة فى هذا الوقت عن أن القضاة لم يسجلوا فى دفاتر المحاكم فى الفترة من 1820 إلى 1850 حكمًا واحدًا ضد الأتراك، وفى بعض الأحيان كان الفلاح الشاكى يتعرض للتعذيب إلى حد القتل دون إدانة التركى.
من بين هذه الأوراق مثلًا، قضية اعتداء الحاكم التركى لطيف أغا، بناحية شونى، عام 1827 على أحد مشايخ الناحية لأنه تلكأ فى دفع «مصلحة وربطيلا»، وهى رشوة لقاء تعيينه كشيخ قرية، تبلغ قيمتها 300 قرش رومى، حيث تعرض للضرب بالكرباج حتى مات مدرجًا فى دمائه.
ولم يعدم القاضى الحجة لتبرئة الأغا إياه، بحجة اختلاف روايات الشهود، وكانت هذه الطريقة سائدة فى تبرئة الأغوات الأتراك.
«عواطلية» وحكام
بقى سؤال مهم: ماذا اشتغل الأتراك تحديدًا فى المنوفية؟.
يعود تعداد النفوس ليظهر بالأرقام الدقيقة أن معظم من عاش فى المنوفية كان عاطلًا أصلًا.
وبخلاف «البطالة»، اشتغل الأتراك فى تحصيل أموال الحكومة، وأعمال السخرة.. انطلق الحكام الأتراك فى أرجاء المنوفية يتعقبون الفلاحين، واستخدموا كل الوسائل للوصول إليهم وابتزازهم، وتفننوا فى تعذيب الفلاحين بكل الطرق لجبايتهم.
وسكن الأتراك قصورًا فاخرة فى القرى والبنادر، وتسجل وثائق الإقليم قوائم هائلة من المأكولات والمشروبات والإسطبلات الضخمة، وأعداد الرقيق البيض والسود، والأثاث المنزلى الحديث الفاخر، الذى كان يملكه هؤلاء الأتراك.
وما يلفت الانتباه أن هؤلاء الأتراك هم أنفسهم الذين عاملوا رقيقهم بكثير من الرأفة، إذ تشير وثائق المحاكم الشرعية إلى عنايتهم بالرقيق بدرجة ملحوظة، ففى عام 1831 أعتق أحد أتباع رستم أفندى حاكم ناحية مليج وناظر الشونة، أحد عبيده وجارية من جواريه وأورثهما فى أملاكه ومقتنياته.
وبعض هؤلاء العبيد أنفسهم تحولوا مع الوقت إلى حكام للأقاليم والنواحى، بعد أن أعتقهم سادتهم، وبعد أن أعلنوا إسلامهم، ولم تكن معاملة هؤلاء للأهالى تختلف عن الأتراك فى شىء سواء فى بطشهم أو عسفهم أو نهبهم أو ترفعهم عن معاشرة الأهالى.
وترد أسماء هؤلاء العبيد دون ذكر لآبائهم أو عائلاتهم، فكان يقال لهم ابن عبدالله أو بنت عبدالله، ومعظمهم جاؤوا من أصول بعيدة من جبال الأناضول ممن وقعوا أسرى فى يد جيش إبراهيم وسيقوا إلى مصر أرقاء، فوزعهم محمد على عبيدًا على حكام الأقاليم.
وتركز وجود هؤلاء الأعيان الجدد فى شبين الكوم ومنوف، وتولى بعضهم مناصب إدارية عليا فى ديوان الإقليم. وقليل من هؤلاء كان يتزوج من الفلاحين، فهم إما يتزوجون من الجوارى، بعد عتقهن، أو من بنات المصريين فى أقاليم أخرى.
أما العائلات المصرية الكبيرة، فكانت تقلد الأتراك فى كل شىء، وكان البعض منهم على صلة بالوالى فى القاهرة.
الخواجات والشوام يتاجرون
يظهر عنصر آخر تشكل منه المجتمع المنوفى، وهو الشوام، الذين شاركوا الأتراك والعائلات الكبيرة فى السيطرة على الحياة الاقتصادية فى الإقليم، وكانوا يقيمون فترات مؤقتة لهذا الغرض.
كما ظهر فى هذا التاريخ الكبيس على الفلاحين من حين لآخر اليهود، الذين مارسوا كل الأعمال المتصلة بالمال والتجارة، لكنهم كانوا يقيمون فى بنادر إقليم المنوفية وليس القرى، وكان هؤلاء الأجانب أيضًا على صلة وثيقة بأعيان الإقليم، خاصة أن هذه العلاقة كانت تقوم على تبادل المنافع بين الطرفين.
كما جلب نظام الاحتكار معه التجار اليونانيين والخواجات.
ولجأت الحكومة كثيرًا لبيع كميات من المحاصيل لتجار من المشارقة المسيحيين واليونانيين وغيرهم ممن كانوا يقيمون فى القاهرة والإسكندرية.
وتوافد على المنوفية هؤلاء الخواجات، الذين ربطتهم بكبار الفلاحين علاقات مالية واسعة، وتمكنوا من احتكار تجارة المحاصيل وشاركوا الفلاحين فى مواشيهم، وكان هؤلاء الخواجات يلجأون لاستئجار بيوت فى شبين الكوم بغرض الإقامة المؤقتة، وكان لهم سماسرة فى كافة النواحى يعقدون لهم الصفقات، وكان الصيارفة الأقباط المصريون هم أدوات الخواجات على ضمان حقوقهم أمام الفلاحين، لذا حرص الخواجات على توثيق علاقاتهم بالصيارفة.
ويلفت النظر حجم التعسف الواقع على الفلاحين أصحاب الأراضى، لأنهم كانوا ملزمين جميعًا بتوفير أكثر من نصف المحصول للحكومة، والباقى يستطيع بيعه للتجار، لكن الحكومة التركية كانت تجبر الفلاحين على بيع المحصول لتجار معينين لهم حق الامتياز لمدة عام أو عامين لشراء المحصول منهم.
هكذا أصبح الفلاح مجبرًا على بيع محصوله لهؤلاء التجار من الخواجات، وإذا حدث وتصرف أحدهم فى محصوله بغير علم الحكومة، وهو ما يستحيل حدوثه تقريبًا، كان يتعرض للإعدام.. أو «يطفش» ويترك أرضه وعائلته إلى أرض أخرى يصبح فيها «متسحبًا».