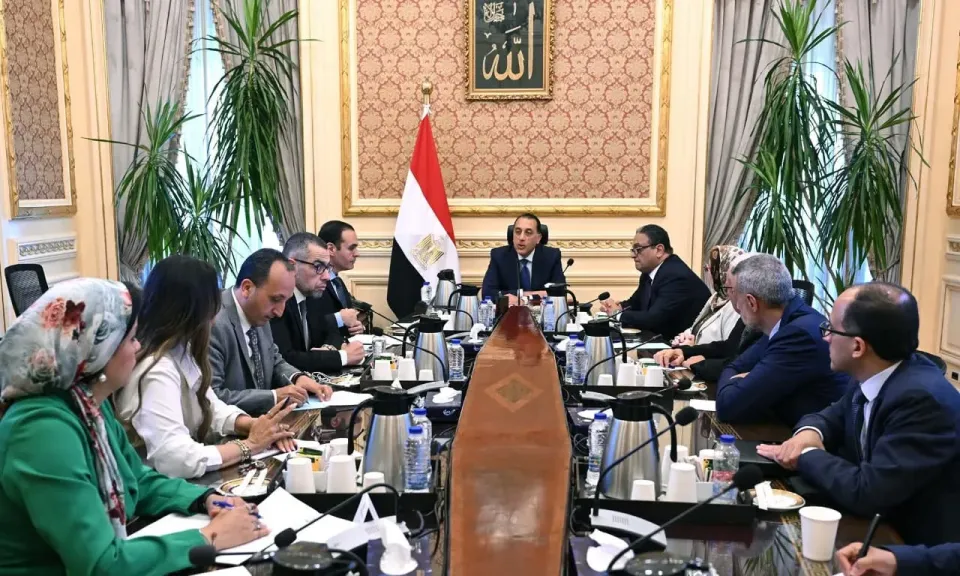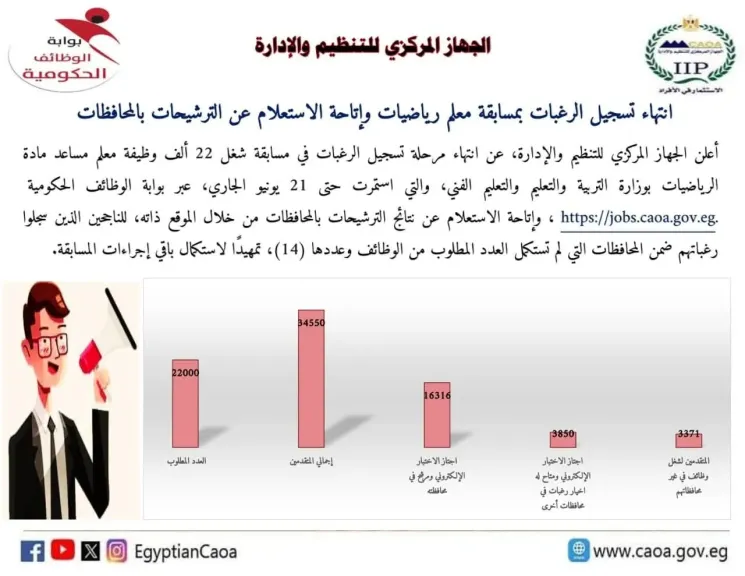د. عادل السيد يكتب: الاشتراكية العربية ومشروع الخلافة العثماني

تيار مثَّلت كثيرٌ من التيارات السياسية ـ مثل تيار الاشتراكية العربية وتيار الإسلام السياسي ـ حالات خاصة نتجت عن فكر الأزمة الاجتماعية، ولنأخذ التيار الأول لنرى كيف نتجت تيارات اشتراكية بداية كنظرية، ثم كتطبيق، من تيار فكري يمثل أزمة اجتماعية فيما يتعلق بمطالب العمال والفلاحين في مواجهة الطبقة المستغلة (الطبقة الرأسمالية) بعدما وصل المجتمع التجاري-الصناعي إلى ذروة الثورة الصناعية منتصف القرن التاسع عشر، وبَدَتْ أحياء الفقر الشاملة لعمال الصناعة الثقيلة والمتوسطة ـ بالإضافة إلى جماعات البطالة المتفشية بينهم ـ تبدو بوضوح على أطراف وهوامش مدن صناعية مثل ليفربول وليدز وشيفيلد في بريطانيا ومدن عديدة أخرى في ألمانيا وفرنسا وإيطالية، بدأ معها المنِّظرون من كُتَّاب اقتصاديين وروائيين في الكتابة معها بغزارة عن بؤس العمال وفقرهم، وتحليل الوضع الاجتماعي-الصناعي شاملًا لتقسيم العمل وحقوق العمال بعد تغريبهم عن منتجاتهم والتوصل معها إلى نظرية فائض القيمة، وكيف يتحول معها مُنْتَج الفلاح مثل القطن ـ المُشترى منه بثمن بخس ـ إلى منسوجات ليس في مقدرته المادية أن يقتنيها، علاوة على النَّساج وهو العامل الذي يحوِّل مادة القطن إلى أنسجة تُصنع منها الأقمشة والملبوسات غالية الثمن، والتي لا يستطيع هو بدوره أيضًا أن يقتنيها، على حين يذهب الربح ـ معظم الربح ـ الناتج عن عمل الفلاح والناسج وصانع ماكينة الإنتاج إلى وسيط السلعة إلى السوق (أو السمسار)، بالإضافة الى التاجر المروِّج لها، بينما يحصل الفلاح والنساج وصانع الماكينة على فتات الربح، والمُسمى بالأجر اليومي أو الشهري، والذي لا يستطيع أن يوفر منه لنفسه أو لعائلته قوت يومه، بينما يقوم الوسيط والتاجر بالعمل على تراكم الربح إلى ثروات، وإعادة استثمارها في عمليات انتاجية استغلالية أخرى، ومعها تتسع دائرة استغلال الفلاح والعامل وصانع الماكينة من جديد وعلى نطاق أوسع.
ومن هنا قام مفكرون (مثل كارل ماركس وفريدريش إنجلز كمنظِّرين، ثم لينين كمطبق لأفكارهما) بطرح أفكار بُغية التوصل إلى حل ينفي الاستغلال عن الطبقة العاملة المُسْتَغَلَّة؛ بغرض إحلال عدالة اجتماعية، وهذا ما أدى في النهاية إلى قيام جماعات شبابية باعتناق تلك الأفكار والعمل على تطبيقها، وما كان ذلك ليتم إلا بثورات أَسَّست دولة الطبقة العاملة في دول صناعية كروسيا، أعقبتها محاولات أخرى في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطالية وغيرها من مسارح الثورة الصناعية الكبرى، ولكنها لم تنل حظها مثلما كان لها في روسيا.
وكنتيجة لذلك كله ظهر شعار (يا عمال العالم اتحدوا) كشعار لدولة الفكر الاشتراكي وأحزاب العمال القائمة على ديكتاتورية الطبقة العاملة والتي لم يكن لأحد الحق في أن ينافسها على مكانتها داخل المجتمع الاشتراكي، وأصبح عدو هذه الطبقة هو الرأسمالي المستغِل، ومع الفكرة دارت مناقشات حول مَن له الحق في أن يكون رأسماليًّا في دولة حزب العمال والفلاحين، وهي التي انتهت بأن الدولة هي الوحيدة التي لها الحق في أن تلعب دور الرأسمالي الوطني، هذا علاوة على احتكار الدولة ذاتها للممارسة السياسية والتمثيل السياسي، ومن هنا لم يكن هناك مكانًا لفكر بديل داخل هذه المنظومة، وعليها جرت محاربة كل مَن سوَّلت له نفسه التفكير في الخروج عن النص الموضوع كإطار لجماعة العدالة الاجتماعية.
ومع ثورات الشباب من الضباط وغيرهم من ممثلي الطبقة المتوسطة في دول الجنوب العالمي ـ في خمسينات القرن الماضي ـ على نُظم كانت في الأساس تمثل بدايات لليبرالية الغربية (والبعض يسميها بـ«شبه الليبرالية»)، وهي التي اتخذت من التمثيل البرلماني وتعدد الأحزاب والقضاء المستقل وحرية الصحافة والحراك الاجتماعي بشكل عام مبدأً صريحًا لها، ظهرت اتجاهات سياسية بين الحُكَّام الجُدد تحوَّلت رويدًا إلى الفكر الاشتراكي.
وربما كان ذلك التحول في برنامج ثوراتها الموضوع والمعنون بـ (بناء حياة ديمقراطية سليمة) قد عُدَّ نتيجة طبيعية للضغوط التي كانت تلك النُّخَب الجديدة تعاني منها في تعاملها مع الغرب (الاستعماري)، ومع مواقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الكتلة الشرقية ذات التوجه الاشتراكي، ومحاولة إقامة تحالفات عسكرية توجه لمحاصرة تلك الكتلة، دون أن يكون لها دورٌ في الماضي الاستعماري، وكان ذلك دافعًا لتلك النخب كما في الحالة المصرية في إفريقية والحالة الكوبية في أمريكا اللاتينية في الاعتماد على النموذج الشرقي والحزب الواحد في تشكيل مجتمعاتها في خمسينات وستينات ذلك القرن.
وتمثل الاعتماد على النموذج الشرقي في كل من مصر وكوبا، كمثال، على معاداة التطور الرأسمالي الليبرالي للدولة، فالدولة أصبحت محل النموذج الشرقي المقتدى تملك مقدرات العمالة والعملية الإنتاجية والسوق وتديرها بواسطة أجهزة مركزية خاضعة لها.
ولكن الحالة المصرية أدخلت تعديلًا على مفهوم «ديكتاتورية الطبقة العاملة» المتضمن للعمال والفلاحين ليشمل الرأسمالية الوطنية والكتاب والمثقفين والجنود كعناصر لما سُمي وقتها بتحالف «قوى الشعب العامل»، ومعها سُمِي الحزب الحاكم بالاتحاد الاشتراكي العربي.
ومثَّلت كلمة العربي هنا فكر الدولة، فقد كان اشتراكيًّا كإطار، وعربيًّا منسوبًا إلى من يقوم به، وعليها صارت تلك الاشتراكية محددة بإطارها العربي، وهو ما ظلت عليه إلى أن سمحت الظروف للمعارضين الكامنين داخل الإطار النخبوي بالتحول إلى النهج شبه الرأسمالي والليبرالي الشكل مرة أخرى.
أما تيار الإسلام السياسي القائم على وحدة مسلمي العالم في دولة الخلافة فكانت جذوره متعمقة في الدولة العثمانية، وكان لذلك إطار سياسي ومجتمعي آخر غير الذي نعاصره اليوم، فعلى مدى القرنين الثامن عشر والقرن التاسع عشر استولت روسيا القيصرية على كثير من مناطق مسلمة في أسيا الوسطى وبها مدن إسلامية تاريخية مثل سمرقند وبُخارَى وَاسْتَغاث أهلها بالسلطان العثماني لنجدتهم وهو الذي كان في حيرة من أمره حيث لم تكن هناك حدود لهذه المناطق مع الدولة العثمانية وكانت إيران (الشيعية) تفصل بين هذه المناطق وبين الدولة (السُّنِّية)، ولكن هذه الاستغاثة مثلت واقعًا كان العثمانيون في حاجة إليه لبيان قوتهم أمام القوى الغربية (المسيحية).
بعدها خسرت الدولة كل مناطق شمال البحر الأسود ورومانيا وبلغاريا واليونان والبلقان مما سبب كارثة ديموغرافية للدولة حيث تحملت مع هذه الخسارة عبء إيواء ملايين من المسلمين النازحين إليها منها، فقامت عليها بإيوائهم في كثير من مدن الأناضول وولاياتها العربية في سوريا الكبرى (الشاملة لدول سوريا ولبنان وفلسطين والأردن اليوم) بالإضافة إلى العراق.
ويذكر المؤرخون دوايت لي وبيكر وديرنجيل أن عدد المسلمين الذين لجئوا إلى الدولة من المناطق المذكورة أعلاه فاق السبعة ملايين بكثير، ومعها باتت الدولة في أزمة تتعلق أولًا بإيواء هؤلاء وأزمة الموارد الناجمة عن خسارة تلك المناطق الغنية ثانيًا، ومعها لم يتبق للدولة سوى رعاياها المسلمين من الأتراك والعرب ولم تعد هناك مواردًا تأتي مع جفاف تلك الآتية لها من مناطق البحر الأسود والبلقان.
ولو عدنا قليلًا إلى الوراء لوجدنا أن لواء «العصبة الإسلامية» كان قد ظهر للوجود بعد أن قامت العُصَب الألمانية Pan Germanism واليونانية Pan Hellinism والسلافيةPan Slavism، كدول مستقلة لوطنيات كان بعضها (كاليونانية والسلافية) في صراعات طويلة وخضوع طويل أيضًا للدولة العثمانية؛ مما دعا للتفكير الجدي في فكرة العصبة الإسلامية Pan Islamism.
ولو عدنا إلى تقاليد تولي السلاطين العثمانيين مهام الحكم، (كما ذكر الكاتب التركي سليم ديرنجيل في مقاله: الشرعية في الدولة العثمانية) في عهد بعض السلاطين قبل عبد الحميد الثاني (١٨٧٦-١٩٠٩)، نجد أن عادة (تقليد السيف) ـ أو سيف الخلافة ـ كان قد بدأ تعميمه مع تولى السلطان محمود الثاني عام ١٨٠٨ للحُكم، حيث قُلِّدَ بسيف الرسول وسيف السلطان سليم الأول معًا، وكان لسيف الرسول دلالة على الخلافة ولسيف السلطان سليم الأول دلالة على مكانة السلطان، وبهما كان التعبير عن شمولية مكانة السلطان-الخليفة، فإذا كانت مهام السلطان تشمل جميع رعايا الدولة ـمن مسلمين وغير مسلمين ـ فإن مهام الخليفة كانت محصورة فقط على رعاياه من المسلمين في الدولة، وتوسعت نظريًّا لتشمل المسلمين في كل بقاع الأرض، كمسلمي الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقية أيضًا.
ويُذكر هنا أن هناك رواية حول تقليد الخليفة المتوكل ـ آخر الخلفاء العباسيين ـ سيف الرسول ـ أو ما سمي بسيف الخلافة ـ للسلطان سليم الأول عام ١٥١٧ بعدما قام الأخير بالاستيلاء على بلاد الشام ومصر، وهو السيف الوحيد الذي أُستخدم في حفل تقليد السلطان عبد المجيد عام ١٨٣٩، والسلطان عبد العزيز عام ١٨٦١، والسلطان عبد الحميد عام ١٨٧٦.
ويذكر الكاتب درينجيل أن المادة الثالثة من دستور مدحت باشا لعام ١٨٧٦ ـ وهو عام تولي السلطان عبد الحميد الحكم ـ أقرَّت بحق العثمانيين في «الخلافة الإسلامية العظمى»، وأن المعارضين داخل الإطار السياسي العثماني من العثمانيين الشباب كانوا من محبذي إيديولوجية العصبة الإسلامية القائمة على فكرة الخلافة العثمانية، ففي الوقت الذي بدأت فيه بروسيا بجمع شتات الإمارات الألمانية في دولة واحدة، وقيام جماعة غاريبالدي وكافور بتوحيد المقاطعات الإيطالية في دولة واحدة على أسس وطنية، كان على العثمانيين أن يقوموا بنفس العمل ولكن على قواعد دينية؛ حيث إن مفاهيم الولاء لديهم في ذلك الوقت لم تكن في صالح مفاهيم الوحدة الوطنية كما كانت للسلافيين أو الألمان والإيطاليين، بمعنى أنها لم تكن تهدف لوحدة كل رعايا الدولة على خلاف دياناتهم من أتراك وعرب وغيرهم، ولكنها كانت تحمل لواء عصبة الإسلام، وأصبح العرش العثماني معها يتخذ الخلافة العثمانية كوسيلة لتثبيت شرعيته بين مَن تبقى له من الرعايا، وكسلاح ديني ضد تدخل القوى العظمى الأخرى (المسيحية) في شؤون الدولة.
أما بالنسبة لذلك السلاح الديني فقد كان على الدولة العثمانية إيجاد بعض القواعد التي يمكن أن تقف عليها مثبتةً للهوية الدينية، وفي أغسطس عام ١٩٠١ قام السلطان عبد الحميد بإرسال تقرير لوزرائه مذكِّرًا لهم بقواعد الحكم العثماني الأربعة التي كان الصدر الأعظم رشيد باشا قد أرساها، وتمثلت في الإسلام ودوام حكم الأسرة العثمانية، وحماية الأراضي المقدسة في مكة والمدينة (والقدس)، وأخيرًا ديمومة بقاء إسطنبول كعاصمة للدولة؛ وبذا صارت هذه القواعد تمثل شرعية حكم الأسرة العثمانية والتي أصبحت عليها إسلامية صرفًا.
وكانت بريطانيا خلال فترة عدائها لروسيا القيصرية وتقربها من الدولة العثمانية لا تحبذ فقط إيجاد علاقة من التواصل بين المسلمين في تاج مستعمراتها الهند (وكانوا وقتها أربعين مليونًا) والسلطان العثماني، بل وتشجع على قيام عصبة إسلامية تربط رعاياها من المسلمين بالسلطان في إسطنبول وكانت تلك هي البداية لفكرة العصبة الإسلامية.
وقد قام كثير من مبعوثي السلطان في بلدان جنوب شرق آسيا (الهولندية حينذاك) بكتابة تقارير عن حالة المسلمين فيها وتوقهم لأن يصبحوا رعايا للسلطان، كما كان للسلطان من ينقل له الأخبار من مختلف المناطق الإسلامية في الهند، ويتابع الصحف المحلية المسلمة وينشر فيها مقالات لتأكيد تواجد وحضور السلطان-الخليفة.
وذكر الكاتب ديرنجيل أنه في سوريا العثمانية كان التماثل على خلفية السلطان-الخليفة مستحبًّا، وذكر أيضًا أن الإمام محمد عبده ـ والذي كان مشهورًا كواحد من الإصلاحيين الدينيين وقتها ـ «يعتبر النظام العثماني بقية من بقايا الاستقلال السياسي للأمة الإسلامية (عن أوربا)، ومع غيابه سيفقد المسلمون كل شيء ويصبحون بدون قوة كاليهود».
ومن الأهمية في هذا الصدد ما ورد في تقارير علي فروح بك ـ المندوب السامي العثماني لبلغاريا ـ عام ١٨٨٣، ودعوته لعقد مؤتمر لممثلي مسلمي العالم في إسطنبول بحجة أن القوى المسيحية لها روابطها التي تجمعها (بهدف تدمير الخلافة ومنع وحدة كل المسلمين)، على أن تكون مناسبة تلك الاحتفالية هي مناسبة مرور ٤٠٠ سنة على تولي العثمان للخلافة من العباسيين.
وكان عام ١٩١٧ هو العام الذي سيعقد فيه هذا المؤتمر الشامل لكل ممثلي مسلمي العالم، ولكن هذا العام كان من بشائر هزيمة الدولة العثمانية التي لاحت في الأفق بعد استيلاء البريطانيين على القدس ـ وهي واحدة من مدن المسلمين المقدسة ـ في ديسمبر من هذا العام- عام الاحتفالية المرتقب.
ومع هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى فقدت الدولة ـ بعد مؤتمرات السلام بين عامي ١٩٢١ و١٩٢٣ في فرنسا ـ كيانها ذاته، وقامت على أطلالها دول اليوم من تركيا والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وقادت أيضًا إلى فك ذلك الرباط الذي كان موجودًا بين مصر ـ ذات الحكم الذاتي ـ والدولة العثمانية، ومعها لم يعد هناك سلطان ولا خليفة وانتهت مؤسسة الخلافة رسميًّا بإعلان مصطفى أتاتورك علمانية الدولة.
هذه كانت مقدمة لنقاش دار بين العرب الواقعين تحت الاحتلال البريطاني (مصر والسودان والعراق والأردن وفلسطين) والفرنسي (سوريا ولبنان) حول مكانة الخلافة، وكان بعض حكام هذه الدول آنذاك قد حاول أن يملأ فراغ موقع الخلافة، وبقي الوضع على ما هو عليه حتى قامت جماعة من الشباب الذي لم يتجاوز الثلاثين من العمر يرأسها معلم في مدرسة ابتدائية (حسن البنا) بتشكيل جماعة من الإخوان عام ١٩٢٨ في مدينة الإسماعيلية؛ ليعكس ذلك كله الوضع الذي آلت إليه الحالة بعد غياب الخلافة العثمانية.
ولنطرح سؤالًا حول المدينة التي أسست فيها الجماعة ـ الإسماعيلية ـ فقد كانت الإسماعيلية هي أحد معاقل البريطانيين في مصر، وعليها لنا أن نفهم أن الوجود البريطاني كان كثيفًا فيها ومع هذا الوجود الكثيف كان متطلبات الحياة الغربية ـ من مطاعم وحانات ودور العبادة وغيرها ـ ماثلًا للعيان، خاصة لمن كان متمسكًا بدينه ومرتبطًا بشكل ما بمركزية الخلافة العثمانية التي آلت على يدي هؤلاء المتواجدين في المدينة وحلفائهم إلى نهايتها، ومن كان يعادي هذا التجمع كان يعادي بالفكر أيضًا طريقتهم في الحياة، وبذلك نجد أن حسن البنا ـ مدرس المرحلة الابتدائية ـ قد وضع في برنامج الجماعة وسيلة التربية الدينية والاجتماعية كوسيلة لرقي المجتمع على الطريقة التي تخالف طريقة البريطانيين.
ومع هذا البرنامج استدعيت بعض ملامح العصبة الإسلامية العثمانية من وحدة المسلمين، رغم الاختلافات الثقافية الكبيرة بين مسلمي جنوب شرق ووسط وغرب آسيا (حيث التكتلات الإسلامية الكبرى) وشمال إفريقية، فلكل من بلاد هذه المناطق عاداته وتقاليده الحضارية والإسلامية أيضًا، ولكن يمكن أن يكون القَصْد هنا من «وحدة مسلمي العالم» هو وحدة المشاعر والقيم ومركزية الحج ومناسكه المقدسة التي تجمع كل عام ملايين المسلمين، ومع ذلك ليس هناك حديث عن وحدة إقليمية تشملهم جميعًا في دولة الخلافة.
ولا شك أن مؤتمرات القمم الإسلامية ـ والتي عُقدت للمرة الأولي مع نهاية العقد السادس من القرن الماضي ـ كانت حافزًا على تفاهم التجمعات الإسلامية، وعلى أن كل دولة لها إطارها الديني التمثيلي، حيث لم تكن هناك دعاوي فيها بالمطالبة بإحياء مشروع الخلافة العثماني عدى عن جماعات خرجت عن ذلك الإطار واتخذت سبيل العنف طريقها لتأسيس خلافة يتعدى دورها الدولة الوطنية.
وأخيرًا، إنها الأزمات الاجتماعية-السياسية التي تُملي على نخب المجتمعات التفكير في حلول حول كيفية الخروج منها بأقل قدر من الخسائر وأكبر قدر من الربح، وكثيرًا ما تنجح هذه النخبة أو تلك في إيجاد المسيرة الصحيحة، والتاريخ يثبت دائما أن العكس قد يكون صحيحًا أيضًا.
وهناك قول لفيلسوف قدَّم لكتاب عن أصول الفلسفة اليونانية يقول: «إن مشكلةً تنبع من مشكلة أخرى بناء على ضرورة داخلية، وإن أي نظام يلي سابقه بناء على عوامل التقدم أو التكامل أو التناقض والأضداد، وهكذا فتاريخ فلسفة أي شعب من الشعوب يعكس تطور فكره ومعها يصبح «تاريخ المعرفة» ـ وإلى حد ما ـ هو «معرفة للتاريخ».