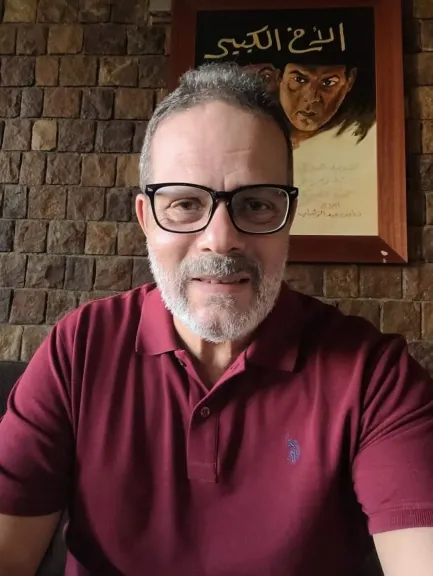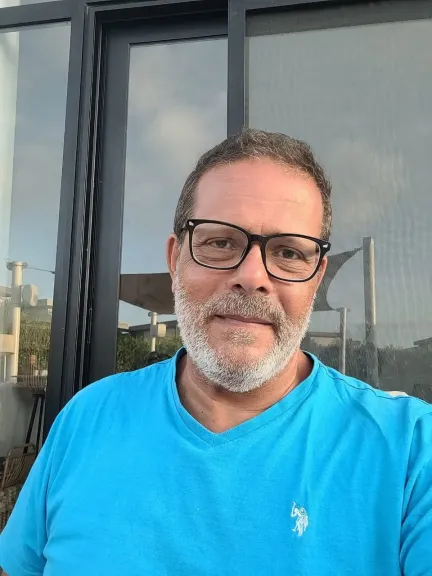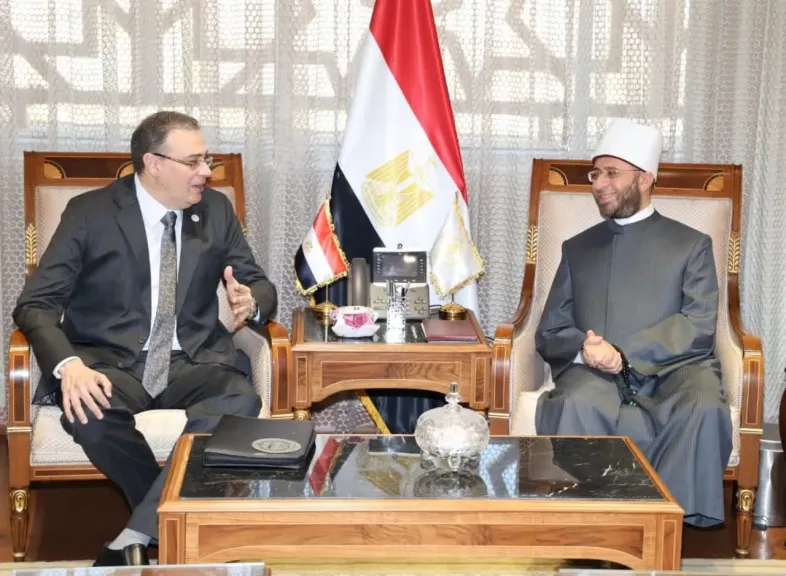إحياء الفلسفة وفلسفة الحياة

ملاحظةٌ لا تخطئها عين ولا يحيد عنها فكر، إنها مدرسية الفلسفة في عالمنا العربي، فالفلسفة عندنا حبيسة الكتب وقاعات المحاضرة في كليات الآداب، ولا صلة لها بالواقع، وكلنا يعرف كم تعاني من سوء السمعة وضعف التقدير، بل إنها صارت لدى الكثيرين مردافة للكفر والإلحاد!
مع أن الباحث المدقق لن يبذل كبيرَ جَهْدٍ حين يكتشف قوة براهين الفلاسفة المؤمنين بوجود الله، وهي قوة توافرت من تماسك البرهان ومنطقيته، ونحن إذا تكلمنا عن البرهنة فهي دون شك صناعة الفلاسفة وهم أقدر عليها من غيرهم.
والفلسفة كما علمنا أستاذنا الدكتور "أحمد فؤاد الأهواني" إما حية متصلة بالجمهور، وإما ميتة لا نراها إلا في المدارس والجامعات. وتاريخ الفلسفة الذي درسناه على مدار سنواتٍ أربع في الجامعة يُنبئنا أنها كانت مزدهرة ذات يوم، حين استجاب الفلاسفة لواقعهم وارتبطوا بمشكلات مواطنيهم فتأملوها وشَخَّصُوا الداء وكتبوا العلاج من وجهة نظرهم، وحين وضعوا تحت مجهر البحث النظم الاجتماعية القائمة وتسائلوا هل تصلح للتطبيق أم أن هناك ما هو أنفع منها؟ وحين وضعوا تفسيرًا للكون والحياة يرون أنه يلائم عصرهم ويؤدي إلى التقدم ولم يَجْتَرُّوا ما كان عليه الآباء.
باختصار يمكن القول إن الفيلسوف يوم نزل من برجه العاجي إلى أرض الناس وتعثر في أوحالهم وناقش ما هم عليه من نقصٍ وفساد، وأرشدهم ودَلَّهُم واحتمل اتهاماتهم وأعطاهم مقابل السب حلماً ونظير الهجوم علما، ثم أخذ بأيديهم نحو التجديد، هنا فقط عاشت وانتعشت الفلسفة.
والأمثلة على هذا كثيرة، فلو ركبنا آلة الزمان إلى عصر فلاسفة اليونان، لرأيناهم على اتصالٍ بالناس والحياة، خذ عندك "فيثاغورس" الذي لم يقتصر على كتبٍ يصنفها، بل منح تلاميذه عيون حكمته وأنشأ لهم مدرسة ينتظم فيها الآلاف، و"سقراط" الذي كان يدخل البيوت فيبث فيها فلسفته ويعلم الناس في البساتين والملاعب، و"أفلاطون" صاحب الأكاديمية التي تنسج اليوم جامعات العالم على منوالها، وهو الذي سافر خصيصًا إلى جزيرة "صقلية" ليعلم ملكها الفلسفة فيطبق بهذا نظريته في "المدينة الفاضلة" و"أرسطو" الذي أسس مدرسة على غرار أستاذه أفلاطون وكانت بالمعنى الحرفي جامعةً متكاملة، وفيها أصناف الحيوان والنبات والخرائط؛ حتى لا تكون دراسة الفلسفة نظرية مجردة، بل تدعمها أصناف الحياة ويؤيدها النظر والحس، ولا ننسى أنه معلم الإسكندر الأكبر.
ولم تقتصر "حيوية" الفلسفة على ارتباط الفيلسوف بالجماهير والحاكم، ومشاركته الفاعلة في الحياة العامة وقيامه بدوره في التعليم الأكاديمي أو التأليف العلمي، بل كان هناك سبب إلى جانب هذا هو الذى غَذَّى حيوية الفلسفة ونماها وساهم في تطوير الفكر الإنساني، وهو"النقد الذاتي" عند الفلاسفة؛ حيث كان الفلاسفة ينقدون أفكارهم بأنفسهم ويطورونها كلما دخلوا في مرحلة جديدة من مراحل عمرهم، فمثلاً نرى أفلاطون الشيخ ينقد أفلاطون الشاب ويعدل كثيرًا من آرائه، وهكذا..
وظل الأمر على هذا النحو إلى أن دخلنا في العصور الوسطى، وأوشكت الفلسفة على الهلاك من خلال أساتذة وطلاب قنعوا بحفظ كتب القدماء، وقلدوا أرسطو كما لو كان إمامًا دينيًا! وأصبحت الفلسفة عبارات يتوه العلماء في حل طلاسمها وشرح معانيها، ودخل أبناء الفلسفة في نزاعات لفظية أماتت حكمتهم وضيعت علمهم، ولم يسلم المسلمون من هذا فقد أصبحت الفلسفة في مرحلتها المتأخرة عندهم ألغازًا تضيع العمر؛ فساهم هذا في منح الفقهاء مبررًا جاهزًا لتحريم الفلسفة والقول بأنها علمٌ لا ينفع.
وقد حاول "ابن رشد" محاولة نشكره عليها في إنعاش الفلسفة العربية، فقرب الفلسفة من الدين والدين من الفلسفة واستبان للناس أنهما ليسا غريمين، ولكن صوت الجهل كان أقوى، وزور عليه أعداؤه ملخصًا فلسفيًا زعموا أنه ألَّهَ فيه الكواكب، ولو صحت نسبة هذا الملخص إليه لما كان فيه مستند لتكفيرهم لابن رشد؛ لأنه كان ينقل هذا القول عن صاحب الأصل الذي اختصره، وناقل الكفر ليس بكافر.
ثم وافانا عصر النهضة ودبت الحياة في عروق الفلسفة، وثار "بيكون" و"ديكارت" على تعاليم أرسطو، ووضع "ديكارت" حجر الأساس للفلسفة الحديثة فهو أبوها، ولا ننسى أيضًا ريادة "بيكون" وإسهامه في إنشاء هذه الفلسفة، ولا تزال الفلسفة حتى الآن تتطور في الغرب وتموت عند العرب كل يوم، وتُقتًل ويقتل معها أي نزوع إلى التفكير، حتى أصبح الإنسان العربي غير متحضر بل مستهلك حضارة.
وحتى لا نعيد الكَرَّة ونكتب فلسفةً هي إلى الأحاجي والألغاز أقرب، وحتى لا يعتقد العامة أن الفلسفة نوعٌ من التخريف، وحتى يحترم الناس الفلسفة حتى وإن لم تنصرف همة كثرتهم إلى العناية بها فهذا ما لا نطمح إليه، وستبقى الفلسفة نخبوية شئنا أم أبينا، أقول حتى نتلافى كل ذلك، فعلى الباحثين العرب أن يبحثوا في الواقع، وأن ينتجوا قراءات فلسفية للعالم المعاصر بحيث تكون مشكلات النوع الإنساني الراهنة هي محل الأولوية في كل ما يكتبوه، إن الفلسفة إكسيرٌ يداوي عذابات الإنسان، وما أكثر عذابات الناس في حاضرنا.
وحتى إذا ما كتب الباحثون في تاريخ الفلسفة فليكونوا على مذهب "برتراند راسل" في الكتابة؛ فهو الذي صنف عن تاريخ الفلسفة الغربية، وربط هذا التاريخ بالظروف الاجتماعية والسياسية في تاريخ أوروبا، ولأنه كتب ما يُفهَم؛ فقد لاقت تصانيفه ما هي جديرة به من النجاح، وبهذا نفخ "راسل" روح الحياة في تاريخ الفلسفة الغربية.
إن الفيلسوف ليس هذا المجنح الخرافي الذي يعيش فيما فوق العالم المحسوس، وليس هذا العبقري المتأفف من وساخات الحياة، بل هو ذلك الإنسان المتفاعل مع بيئته والمنتمي إليها، والراغب في إصلاحها بعد الفهم والتشخيص.
ونحن نعاني في بيئتنا العربية من وطأة التراث، فنحن في الحقيقة لا ندرس التراث لنقف على ما فيه من مواطن القوة والضعف، الكمال والقصور، العلم والخرافة؛ بل إننا نعبد التراث، ونجتر نزاعات المتكلمين وكأنهم يعيشون بيننا، ونعيد الروح إلى الأئمة فنسألهم عن أخص خصائص حاضرنا، ومهمة الباحث العربي أن يعلن للعرب بالدليل أن التراث ليس إلا تراثًا، وأنه لدى الذهن العربي إمكانية للتفكير بوعي في حاضره ومستقبله، وأنه حين يدرس الفلسفة على طريقة "برتراند راسل" سيعرف كيف يُقَيِّم المفاهيم ويحلل العبارات ويكتشف أمراض أمته، وبهذا نعرف أنه لا مفر من إحياء الفلسفة وفلسفة الحياة.
اقرأ أيضًا: محمد عبد الجليل يكتب: يعني إيه مُدرّسة وبترقص يا لميس؟